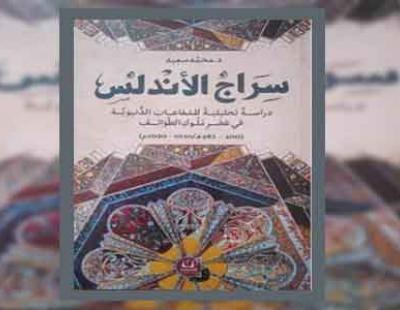الشعر وصراعات «ملوك الطوائف» في الأندلس.
لعبت الشفاعات الدنيوية والوشايات في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (1010 – 1090) دوراً كبيراً في التأثير على مجرى الأحداث، فرفعت أبيات من الشعر عدداً كبيراً من الشعراء إلى مكانة مرموقة في المجتمع ليتقربوا من الحكام، وفي الوقت نفسه سجنت أبيات أخرى أصحابها وتسببت في فرار بعضهم من بلادهم ونفيهم، وربما قتلهم ولم يقتصر تأثير تلك الشفاعات على الحياة السياسية فقط، إنما امتد تأثيرها إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية للمجتمع الأندلسي، فكانت من أهم العوامل التي شكَّلت تاريخ تلك الفترة؛ ولذلك أصبحت دراستها أحد أهم المفاتيح لفهم وكشف الغموض الذي اكتنف كثيراً من أحداث ذلك العصر.
تبرز هذه المهمة على نحو شيق في كتاب «سراج الأندلس - دراسة تحليلية للشفاعات الدنيوية في عصر ملوك الطوائف» للباحث الدكتور محمد سعيد، الصدارة حديثاً عن دار «أقلام عربية» للنشر بالقاهرة. يوضح المؤلف، أن مصطلح «الشفاعة» يحمل الكثير من المعاني، منها أنه مأخوذ من «الشفع»، أي الطلب والتوسل والوسيلة، وهو كلام الشفيع للحاكم أو الأمير أو القاضي أو المسؤول في حاجة يسألها لغيره.
واللافت، أن الشعر كان الوسيلة الأساسية التي استخدمها بعض مثقفي الأندلس وعلمائه حين غضبوا من زملاء وعلماء لهم فقرروا الوشاية بهم لدى السلطة لمنع إدخال أفكار ونشر منتجات ثقافية جديدة. ومن ذلك، إجراء اختبارات لعدد من الأدباء والمثقفين في بلاط السلطة قصد تعجيزهم لمنع اتصالهم بالسلطة كما يلحق بها السعايات والوشايات التي بذلت لعدم نشر كتب ومؤلفات جديدة، مثل حرق كتب ومؤلفات الإمام ابن حزم، ومن بعده ابن رشد.
عصر الفتن
اتسم عصر ملوك الطوائف في الأندلس بالفتن والاضطرابات، لم يقتصر تصارع الملوك فيما بينهم، على التوسع وبسط النفوذ فحسب، بل امتد ليشمل جلب الأدباء والشعراء والعلماء وغيرهم من المثقفين، فضلاً عن استمالة الكثير من القادة والولاة لصفوفهم؛ الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض ولاة الأقاليم والقضاة وقادة الجيوش وكبار رجال الدولة والحاشية والأدباء والشعراء لغضب الحكام وسخطهم لأسباب مختلفة فأصدروا بحقهم عقوبات تأديبية بقدر تهمتهم تفاوتت بين الغضب والتوبيخ والضرب والهجر والإعراض والعزل السجن والقتل!
وأشارت المصادر إلى شفاعات ووساطات بذلت عند هؤلاء الحكام للعفو عنهم والتجاوز عن خطاياهم، كما بذلت بعض السعايات لبعض كبار رجال الدولة لإلحاق الأذى بهم أو لعزلهم عن مناصبهم أو لهجر الحكام لهم والإعراض عنهم. ومن أبرز الأمثلة في هذا السياق، ما حدث مع «ذو الوزارتين» أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد، وكان يوصف بأنه من أعلم أهل الأندلس ومن أهل الأدباء البارعين بما له قوة في البديهة.
وكان لقب «ذو الوزارتين» يُمنح لمن يجمع بين منصب الوزير ويكون أيضاً من الأدباء والشعراء. تمت الوشاية بالرجل في أيام خلافة يحيى المعتلي بن علي بن حمود في قرطبة فنكبه يحيى، واعتقله بسبب وشايات وسعايات أعدائه وحساده، حيث استغلوا ميله إلى اللهو والمجون فأطلقوا عليه ألسنتهم وسعوا به عند الملوك والأمراء فألقي القبض عليه وتم إيداعه السجن، وظل أبو عامر يستعطف يحيى بأبيات شعرية عديدة حتى يفرج عنه، ومنها:
قَرِيبٌ بِمُحْتَلِّ الهَوانِ بعِيدُ
يجُودُ ويَشْكُو حُزْنَهُ فيُجِيدُ
نَعَى ضرَّه عِنْد الإِمامِ فيا له
عدُوٌّ لأَبْنَاءِ الكِرَامِ حسُودُ
وما ضَرَّهُ إِلا مُزَاحٌ ورِقَّةٌ
ثَنَتْهُ سفِيه الذِّكْرِ وهْو رشِيدُ
وظل على هذه الحال حتى تم الصفح عنه وإخلاء سبيله.
ابن زيدون
كان أبو الوليد أحمد بن زيدون من أهل قرطبة، شاعراً بليغاً كثير الشعر شديد الهجاء، وكان من أبناء وجوه الفقهاء في المدينة وعلى مقدرة شعرية ممتازة ساعدته أن يبلغ مرتبة الوزارة. ومن أسباب حقد منافسيه عليه اقتران اسمه باسم «ولادة بنت المستكفي» الأديبة والشاعرة وانغماسه في حياة اللهو والوشاية به عبر الشعر؛ ما أدى إلى اعتقاله وسجنه، غير أن بعض المصادر أشارت إلى أن سبب سجن ابن زيدون الحقيقي يعود إلى أنه اصطدم في بداية عهده كوزير بأحد حكام قرطبة هو عبد الله بن أحمد المكوي، والذي استمع إلى وشايات شعرية به فأمر بسجنه.
وأي كان السبب المباشر وراء اعتقاله، تتفق المصادر الأدبية والتاريخية على أنه سجن بتأثير الوشايات من أعدائه وأما نوع هذه الوشايات فغامض مجهول لم يعرف على وجه القطع، لكن عدداً من الباحثين المحدثين توقعوا أسباباً لسجنه، فمنهم من رأى أن اتهامه بالاستيلاء على عقار لبعض مواليه بعد وفاته أدى إلى سجنه، ومنهم من جعل حبسه سببه هجائه المقذع للوزير ابن عبدوس غريمه في حب ولادة.
يقول ابن زيدون:
وَمِثلِيَ قَد تَهفو بِهِ نَشوَةُ الصِبا
وَمِثلُكَ قَد يَعفو وَمالَكَ مِن مِثلِ
هِيَ النَعلُ زَلَّت بي فَهَل أَنتَ مُكذِبٌ
لِقيلِ الأَعادي إِنَّها زَلَّةُ الحِسلِ
في البداية، لم يستجب حاكم قرطبة إلى تلك القصائد، لكن ابن زيدون لم ييأس، وعاد فخاطب الحاكم في رسالة طويلة قال فيها «وليت شعري ما الذنب الذي أذنبت ولم يسعه العفوُ؟ ولا أخلو أن أكون بريئاً فأين العدلُ؟ أو مسيئاً فأين الفضلُ؟». وهنا اضطر الحاكم إلى إطلاق سراحه.
الأب الغاضب والأمير الخائف
المدهش، أن تمتد دائرة الغضب والوشاية إلى الحلقة العائلية الضيقة داخل الحكم، وتحديداً بين الأب وابنه، ويكون الشعر هو المنقذ والمخلص! حدث ذلك بين المعتضد بن عباد، أحد ملوك الطوائف، حين أراد توسعة نفوذه بالاستيلاء على قرطبة عام 1058، لكنه شعر بالخذلان من ولي عهده إسماعيل، ثم ابنه الثاني محمد.
ويذكر المؤلف، أن الأمر المؤكد من خلال موقف المعتضد مع ابنه إسماعيل، أنه كان حازماً شديداً مع أبنائه، فقد غضب أشد الغضب على محمد، وتوعده بأشد العقوبات بسبب فشله في الاحتفاظ باستقلال مدينة مالقة وعودتها إلى السلطان باديس حبوس، صاحب غرناطة، وكان أهلها يكرهون حكمه ويتمنون أن يصيروا إلى حكم المعتضد بن عباد؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يكونوا تحت أمير بربري فانتهزوا فرصة ابتعاد باديس في غرناطة، وأرسلوا للمعتضد فأرسل ابنه محمداً بن عباد وأخاه جابر، فأسرعا إلى مالقة من رندة واستوليا على البلد إلا القصبة؛ إذ تحصن فيها جماعة من جند باديس وأرسلوا يستغيثون به فأرسل إليهم الإمدادات، فلما وصلت مزقت شمل قوات بني عباد وفر كل من محمد وجابر من أرض المعركة.
أثار ما حدث غضب المعتضد، ونتيجة ما عرف عنه من الشدة والحزم ارتعد محمد ابنه خوفاً منه وقلق على نفسه من أبيه؛ لأنه يعلم عاقبة ما حدث الأمر الذي جعله يفكر في وسيلة أو طريقة يتوسط بها إلى والده ويتشفع بها إليه، فما كان من طريق أمامه غير مخاطبته بأبيات من الشعر، وتلك كانت الطريقة المضمونة والسهلة لمحمد بن عباد، حيث اشتهر بأنه كان بارعاً في الأدب، وكان من أشهر شعراء الأندلس آنذاك.
نظم محمد بن عباد أبياتاً من الشعر خاطب فيها روح الأبوة في أبيه، فنظم القصيدة الرائية التي استعطف فيها واستصرخ عاطفة أبيه ومنها:
سَكِّن فُؤادكَ لا تَذهَب بِهِ الفِكَرُ
ماذا يُعيد عَلَيكَ البَثُّ وَالحذرُ
وَازجُر جفونك لا تَرضَ البُكاءَ لَها
وَاِصبر فَقَد كُنتَ عِنْدَ الخطب تَصطَبِرُ
بهذه الأبيات نجا محمد بن عباد المعتمد من غضب أبيه؛ فعفا عنه والده وسامحه وقبِل وساطته تلك، وبذلك اختلف موقف محمد بن عباد عن أخيه إسماعيل؛ فإسماعيل لم يلتزم التوبة مع والده كما لم يغتنم فرصة عفو والده عنه في حين اغتنم محمد بن عباد فرصة عفو أبيه عنه فالتزم جانب والده وتقرب منه.
ويختتم المؤلف جولته في علاقة الشعر بالصراعات السياسية بالشاعر خلف بن فرج السميسر، الذي اشتهر بهجائه، فكان هجاؤه للملوك والأمراء أكثر من مدحه! ومن ضمن ملوك الطوائف الذين نالهم هجاءه المعتصم، ملك غرناطة، الذي قال فيه السميسر:
بِئْسَ دَارُ ألْمِرْيَةِ اَلْيَوْمِ دَارًا
لَيْسَ فِيهَا لِسَاكِنِ مَا يُحِبُّ
بَلْدَةٌ لَا تمار إِلَّا بِرِيحٍ
رُبَّمَا قَدْ تَهُبُّ أَوْ لَا تَهُبُّ
فاحتال المعتصم، صاحب مدينة ألمرية، على الأمر وأتي بالشاعر، وقال له أنشدني ما قلت فيّ، فقال وحق من حصلني في يدك ما قلت شراً، وإنما قلت:
رَأَيتُ آدَمَ في نَومِي فَقُلتُ لَهُ
أَبا البَرِيَّةِ إِنَّ الناسَ قَد حَكَموا
أَنَّ البَرابِرَ نَسْلُ مِنكَ، قالَ إِذن
حَوّاءُ طالِقَةٌ إِن كانَ ما زَعَموا!
تحقق المعتصم من الأمر، فتبين له أن الشاعر تعرض لوشاية من ملك البربر «بلقين» ملك غرناطة الذي قيلت فيه تلك الأبيات؛ فحاول أن يقضي على السميسر بيد المعتصم، ولكن مخططه باء بالفشل بعدما تحقق الأخير من الأمر، فعفا عن الشاعر.
المصدر: الشرق الأوسط