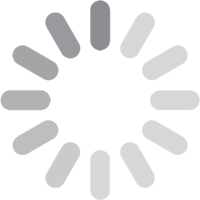العبور الأجناسي تعيينًا
العبور الأجناسي تعيينًا
إن انفتاح بنيات النص الداخلية يعني تشكيل عالمه الخارجي موضوعيا وقصديا بعيدا عن أي اعتبار للزمان الفيزيقي الذي لا دور له في حل التباسات الانغلاق على البنية من جهة، ولا أثر يتركه على طبيعة هذا الانفتاح من جهة أخرى. لتكون البنيات الداخلية النصية شعرية في جمالياتها المطلقة، ولا زمانية في لا نهائيتها المنفتحة تائهة بلا حدود وبالالتباسات عينها حتى تنغلق في إطار خارجي يحدها ويحددها معا.
وليس العبور سوى عملية إعادة تعيين حدود النصوص التي تلاشت في انفتاحيتها ما وراء النصية، لتكون مؤطرة بالعبور ومنغلقة عليه. وبإعادة التعيين تغدو لكل نص ثلاث حركات بنائية: الحركة الأولى تبدأ بالانغلاق لتنتقل بعدها إلى الحركة الثانية التي هي انفتاحية ثم تعود بالحركة الثالثة إلى ما ابتدأت به وهو الانغلاق. وأيا من الحركات الثلاث لا تكون إلا متصلة انفتاحا وانغلاقا ثم انغلاقا وانفتاحا وهكذا يبقى النص منفتحا وفي الوقت نفسه يكون منغلقا محافظا على حديته ومصنفا ضمن جنس من أجناس الأدب.
وبهذا التوصيف العابري لا يعود التداخل او التعالق النصي مُلقيا بالنص في دوامة اللانهائية مسيّبا إطاره الأجناسي كما لن يعود هناك احتكام إلى أسلوبية النص الداخلية وحدها أو تركها والاهتمام بدلها بخارجيات النص السياقية.
إن التحديد الإطاري الذي يحققه افتراض وجود عبور أجناسي الذي فيه يصنف النص أما معبورا عليه أو عابرا هو الذي يحفظ للتجنيس قوالبه كما يمنحه دينامية محددة في تشكلها وامتدادها.
وما يبغي العبور بلوغه هو أن تكون هناك رؤية ثالثة تهتم بأسلوبية النص وتتجاوزها إلى التداخل النصي والاجناسي موجهة عنايتها نحو ضبط فاعلية تجنيس النص من خلال تجسير الصلة بين كتابتين إحداهما ذات قالب والأخرى مغايرة سواء بقالب أو بدونه. وبالعبور تتمكن واحدة منهما من مواجهة التعميم بالتحديد واللاتقولب بالقالب. وهو ما تريده نظريات الأجناس بغض النظر عن طبيعة تعاملها النقدي.
وعندما نقف عند واحدة من نظريات الأجناس في هذا الصدد وهي نظرية ميخائيل باخيتن للرواية وفيها نجده قد عالج التجنيس من خلال رؤية انفتاحية تنظر إلى الرواية بظواهرها الأسلوبية والتداولية المتعلقة بمفاهيم التعدد اللساني والحوارية من دون اعتبار إلى البعدين التاريخي والإيديولوجي. وبالشكل الذي يمركز القارئ ويجعله في حالة تماس مع خارجيات النص الروائي وما على القارئ سوى أن يلمح معانيها لمحا ويستدل عليها بحسب ما لديه من مرجعيات وما اختزنه ذهنه من خبرات.
ويعد مفهوم التعدد اللساني أصواتا ولهجات ومتعلقاته من التهجين والاسلبة بمثابة إضافة مهمة إلى المدرسة البنيوية فاتحا في الآن نفسه مجالا مهما لما بعدها من خلال نظرية باختين الحوارية في كتابيه ( نظرية الرواية) والثاني( شعرية دوستويفسكي) لكنه في كليهما لا يقف عند الأجناس وقوالبها الكتابية بقدر اهتمامه بالبنية الداخلية في تقنياتها الأسلوبية، إلى جانب اهتمامه بالإطار الخارجي في تعالقاته المفتوحة على مصاريعها والتي بسببها وجد باختين في الروائي الكبير دوستويفسكي أنه»( صانع الرواية المتعددة الأصوات polyphone لقد اوجد صنفا روائيا بصورة جوهرية ولهذا السبب بالذات فان أعماله الإبداعية لا يمكن حشرها داخل اطر محددة من أي نوع وهي لا تذعن لأي من تلك القوالب الأدبية التي وجدت عبر التاريخ والتي اعتدنا تطبيقها على مختلف ظواهر الرواية الأوربية)(شعرية دوستويفسكي ميخائيل باختين، ص14)
ويبدو تأثر باختين في نظريته هذه بالرومانسيين ومفهومهم لـ( المطلق الأدبي) الذي رسّخ الصلة بين الفكر والإبداع وجعل تعبيرية الأشكال الكتابية أكبر من أن تضمها قوالب أجناسية. ويعد فردريك شليغل من أهم هؤلاء الرومانسيين وهو القائل إن( كل نظرية للرواية يجب أن تكون هي نفسها رواية مشتملة على النبرات الخالدة للنزوة وعلى فوضى سديم الفرسان.. إن الرواية لا يمكن أن تستحق اسمها إذا لم تكن خليطا من المحكي والنشيد ومن أشكال أخرى)(الخطاب الروائي، ميخائيل باختين)، نافيا بذلك التجنيس عنها.
وعملا بهذا التصور اتخذ باختين موقفا وسطا ما بين التجنيس واللاتجنيس، لتكون الرواية عنده التقاء عدة أجناس وتداخل عدة لغات وأصوات. وإذا كان جورج لوكاش قد وضع نظرية في الرواية بيد أن الفارق كبير بينه وبين باختين فلوكاش تحدث عن مفاهيم الوحدة العضوية والعلاقة والجوهر والكلية المحايثة وبمحمولات فلسفية تجعل الرواية (ملحمة عالم بدون آلهة) في حين تبنى باختين رؤية لا تولي التطور التاريخي اهتماما محاولا رأب الصدع الذي تركته المنهجية الواقعية في تحليل البنية الداخلية للرواية موجها تفكيره لا نحو التجنيس الأدبي وإنما نحو أسلوبية التجنيس ووحداته المتمثلة بـ( سرد مباشر/ اسلبة أشكال السرد الشفوي/ اسلبة أشكال السرد المكتوب / أشكال أدبية متنوعة من خطاب الكاتب/ خطابات الشخوص الروائية أسلوبيا / كتابات أخلاقية وفلسفية/ استطرادات خطب بلاغية، أوصاف اثنوغرافية) ..ولكن هل يكون لهذه الوحدات انعكاس بنائي على القالب الاجناسي لنص ما ؟
الجواب يتضح في قول باختين: (هذه الوحدات الأسلوبية اللامتجانسة تتمازج عند دخولها إلى الرواية لتكون (نسقا أدبيا منسجما) ولتخضع لوحدة أسلوبية عليا تتحكم في الكل ولا تستطيع أن تطابق بينها وبين أية وحدة من الوحدات التابعة لها) فباختين يؤكد بشكل حثيث مسائل النسق واللاتطابق مقتصرا على الرواية وحدها ناظرا برؤية بنيوية وما بعد بنيوية إلى الرواية بوصفها تجميعا للأساليب ونسقا من اللغات.. وهو ما أفادت منه كرستيفا فأسست مصطلحها( التناص)
وبالطبع ليس الطرح الانفتاحي الذي قدمه باختين للرواية بمنقطع الجذور عن منظرين أدبيين أثنين هما سبيت وفينوكرادوف اللذان وجدا في الرواية من الاتساع ما يجعلها شكلا تلفيقيا مختلطا وتشكيلا هجينا يقبل أن تتواجد فيه عناصر شعرية محضة إلى جانب عناصر بلاغية.
وبسبب هذه الاتساعية لم يحدد باختين للرواية موقعا في الأجناس الملحمية والدرامية والغنائية معتبرا أن الرواية دخلت في تفاعل عميق مع هذه الأجناس ومع غيرها من الأصناف البلاغية الحية الصحفية والأخلاقية والفلسفية التي برأيه تضاهي في حجم تفاعلها الأجناس الأرسطية الثلاثة سواء أكان التفاعل سلميا أم كان التفاعل عدائيا، لكنه استدرك أن الخطاب الروائي وإن كان غير قابل لأن يختزل إلى خطاب بلاغي، فإنه يظل محتفظا بأصالته النوعية وسط تلك العلائق المتبادلة المستمرة.
بمعنى أن باختين يقر بأن الرواية جنس أدبي، والفن الروائي خطاب شعري، لكنه يرى هذا الخطاب عمليا لا يندرج ضمن التصور الراهن للخطاب الشعري القائم على بعض المسلمات المتحققة عبر تطوره التاريخي من أرسطو إلى اليوم ضمن أجناس محددة وصفها ب( الرسمية)
لذاك وجه جل اهتمامه نحو الخروج بالأجناس من هذا التطور التاريخي تخلصا مما ينطوي عليه من معضلة مصيرية إيديولوجية واجتماعية تولدت وتكونت من شعرية أرسطو واوغسطين وليبنتز وهامبولدت وجعلت للأجناس مركزية في الحياة الاجتماعية واللسانية والإيديولوجية، تخدم المركزية اللغوية الأوربية.
ومن ثم يتوجب على الأجناس الأدبية أن تخرج من تيار القوى الجاذبة نحو المركز لتنضوي مع تيار القوى النابذة المعاكسة للمركزة، وهنا يأتي ( التعدد والتحاور) اللذان بهما تتفكك تلك المركزية.وعلى الرغم من أن باختين ينحاز إلى القول بلا جدوى التجنيس فإنه لم يصرح بذلك مباشرة وإنما جاء انحيازه بشكل ضمني من خلال توكيده أمرين:
1ـ أهمية تعميق الحوارية في الخطاب الروائي التي تجعل الأجناس (متخللة) أي أنها تسمح بأن تنضم إلى كيانها أنواع الكتابة الأدبية كالقصص والأشعار والمقاطع الكوميدية أو الأنواع الكتابية خارج الأدبية كدراسات عن السلوكيات والنصوص العلمية والدينية..الخ. وعن ذلك يقول باختين:»( إن أي جنس تعبيري يمكن أن يدخل إلى بنية الرواية وليس من السهل العثور على جنس تعبيري واحد لم يسبق له في يوم ما أن ألحقه كاتب أو آخر بالرواية وتحتفظ تلك الأجناس عادة بمرونتها واستقلالها وأصالتها اللسانية والأسلوبية»)
2ـ وهذه المرونة يحققها مفهوم( الصوغ الحواري) الذي يجعل البنية الداخلية للخطاب سلسلة ألسنية وأسلوبية من خصائص الدلالة والتركيب والتأليف.
وتظل نظرية ميخائيل باختين في الرواية هي الأكثر تأثيرا في تاريخ النظرية الأدبية بسبب ما فيها من اهتمام بظواهر أسلوبية وتداولية في مقدمتها موقفها المتصادي مع التاريخ والإيديولوجيا ومناهضتها للمركزية فضلا عن تعددها اللساني وحواريتها.
المصدر: الدستور