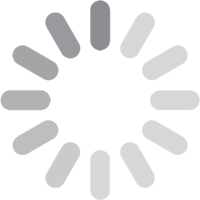وزير الإعلام العُماني يدشّن فعاليات المنتدى الخليجي الأول للكتاب والأدباء
تتواصل فعاليات المنتدى الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء حيث تستضيف مكتبة نزوى العامة الندوة النقدية والتي يديرها الدكتور هلال البريدي حيث يقدم كل من الدكتور عيسى السليماني ورقته بعنوان «بنية الخطاب الشعري.. قراءة أنموذجية في النص العُماني» بينما يقدم الدكتور حافظ أمبوسعيدي ورقته بعنوان «أنساق ثقافية في الشعر العُماني»، ويقدم الأستاذ الدكتور عبدالحكيم الشبرمي من المملكة العربية السعودية ورقته بعنوان «صورة الفأل في الشعر السعودي ـ جائحة كورونا نموذجا» في حين تقدم الدكتورة مريم الهاشمي من دولة الإمارات العربية المتحدة ورقتها بعنوان «تحولات القصيدة الإماراتية الجديدة»، ونيابة عن الشاعر كريم رضي من مملكة البحرين يقدم الشاعر صالح يوسف صالح ورقة بعنوان «التجربة النقدية للشعر المعاصر في البحرين»، في حين تقام الأمسية الشعرية التي يديرها الشاعر إبراهيم السالمي ويشارك فيها من الشعراء هشام الصقري وبدرية البدري وحمزة البوسعيدي وحمد الحراصي برفقة الشاعرة نجاة الظاهري من دولة الإمارات العربية المتحدة والشاعر صالح يوسف من مملكة البحرين والشاعر حمد العمار من المملكة العربية السعودية.
وكانت قد انطلقت فعاليات المنتدى الخليجي في دورته الأولى دورة «الشعر ونقده خلال العقدين المنصرمين» مساء أمس تحت رعاية الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العُماني في مقر الجمعية بمرتفعات المطار حيث بدأت الفعالية بالتوقيع على اللائحة التنسيقية للمنتدى الثقافي الخليجي هو نتاج عمل مشترك بين الجمعيات والاتحادات والروابط الخليجية المعنية بالكتاب والأدباء، وسيقام بالتبادل بين المؤسسات الخليجية المشاركة في المنتدى، تستضيفه سلطنة عُمان في دورته الأولى هذا العام.
وفي الجلسة النقدية الأولى والتي أدارتها الدكتورة عزيزة الطائية وتناولت عنوان الدورة قدم الدكتور عبدالله الزهراني من المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان «سلطة بقاء القصيدة البيتية عند جماعة شعر في نادي مكة الثقافي الأدبي» حيث سلط الضوء على بقاء القصيدة البيتية عند جيل من الشعراء يزيدون عن خمسين شاعرا من الذين انضووا تحت مسمى هذه الجماعة لمدة عام حيث تناول فضاء الموضوعات وشمل الفضاء الوطني، وفيه: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ويوم البيعة لخادم الحرمين الشريفين، كما قدم في وصف المدن الفضاء الديني والذي يقصد به المناسبات الدينية، إضافة إلى فضاء التشكيل الفني من عتبات العنوان و«الفضاء الشعبي»، و«القصيدة والصورة»، و«التصريع»، و«بين البيتي»، و«التفعيلي»، و«الرافد الشعري».
كما قدم الدكتور حمود الدغيشي من ورقة بعنوان «مُتلازَمة الظَّلام والظِّلال» قراءة نقدية ترصد مُتلازمة الظلام والظِّلال في تجربة عبدالله البلوشي الشعرية، إذ تتكدس هذه المتلازمة بتشظياتها المتناثرة في التجربة الشعرية لدى الشاعر، لتشكل ظاهرة تستحق الوقوف عندها، وعبدالله البلوشي شاعر يعيد صياغة الطبيعة بحجم الجرح النازف فيه، شكّل رحيل الأم انقلابا على المستوى النفسي والشعري ـ إذا صحَّ التعبير ـ وشكّلت صورة الليل والشجرة في دِيوانَيْهِ «معبر الدَّمع» و «أوَّل الفجر» كثافة دلالية انبثقت منها متلازمة الظلام والظلال.
يقول «الدغيشي»: لقد أفضتْ تجربة الموت القاسية بالشّاعر أنْ جعل العتمة الوعاء الذي يحتضن أحزانه، ويقْذف بداخله دموعه وأوجاعه. والعتمة لا تشير هنا إلى ظرف زمانيّ تتفاعل فيه أحداثٌ فحسْب بقدر ما تشير إلى قتامة اللوْن الذي ينقل العتمة من خصوصيّتها الظرفية إلى عموميّة الغياب؛ حين تتماهى الذّات في قتامة العتمة، وتذوب في السّواد؛ لتسْتر دموعها، وتخبّئ أوجاعها. يسْتحضر البلوشيّ في فجائعيته بفقْد أمّه خطابه الخاصّ بلغة الفقْد، المتْرعة بظلام اللّيل وظلال الأشجار، ولا ريْب في أنّ «علوّ اللّيْل» بظلامه الأسود المركّب، والشّجرة الفارعة بظلالها الحاجب النّور، صورةٌ ذات كثافة دلاليّة، وهي إسقاطٌ لصورة الذّات في علاقتها بمتلازمة العتمة (الظّلام والظّلال)، حيث «قمر العمر انْطفأ»، وهذا «الانطفاء» حجب عن الذّات صوت العالم الحيّ في الخارج، لتتوحّد بأصوات العتمة (جلبة الرّيح، وأنين الأرض البعيدة، ودمْدمة عظام الأمّ، وأجْراس زوايا اللّيْل).
ويضيف الدكتور حمود الدغيشي : يبدو أنّ الحزْن يتشاكل لدى الشّاعر؛ فكلّ القبور المسجّاة تحت تلك الشّجرة هي قبْر أمّه، وهنا تتحوّل مساحة الحزْن إلى اسْتجابةٍ انْفعاليّةٍ متطرّفة تجْترّ الأفكار والصّور الماضية المحْبطة أثناء تعرّضها لمثيرٍ خارجيّ «القبْر»؛ إذْ إنّ غياب الألم أصعب من الألم، وإنّ فقدان الموضوع (موضوع الحبّ) يحيل هذه الذّات المتألّمة إلى الاشتغال على الحداد، ويعدّ الحداد نشاطًا نفسيًّا، واسْتجابةً لتجْربةٍ أليمة، يعيش فيها الفرد حالةً من الاكْتئاب؛ جرّاء فقدان موضوع الحبّ، وهو في ممارسة طقوسه (الحداد) يحافظ على أمْن «الأنا» واستقرارها، وبالمقابل فإنّ امتناع «الأنا» عن الممارسة يعرّضها للْخوْض في صراعاتٍ نفسيّة، فيجعلها غير قادرةٍ على التكيّف مع واقعها الداخليّ والخارجيّ الموضوعيّ؛ أيْ لن يكون هناك نضْج نفْسيّ. فالحداد يذكّر بالموت، ولكنْ ليس بالضرورة أنْ يحمل كلّ موْتٍ معه حدادًا؛ فهو مرتبط بأهميّة الشخص المفقود، إذ إنّ المهمّ في الحداد هو التّعلّق والفقدان. لقد تحوّل هذا الفقد إلى فكرةٍ تـقْـلق الشّاعر، فأخذ يسقط هذا القلق على الأشياء الخارجيّة التي تكثّف من صورة العتمة في لون السّواد (الظّلام والظّلال) وما يرافقهما من عزلةٍ عن العالم الخارجيّ.
في حين قدمت الباحثة الكويتية أمل عبدالله ورقة عمل بعنوان «الحركة الشعرية في الكويت» (مقاربة لتحديد المراحل والمرابح) تطرقت فيها إلى ما يتصـل بتطـور الحركـة الأدبيـة عامـة والشـعرية خاصـة وقالت: إن الساحة الشعرية في الكويت ليست استثناء من تلك القاعدة، فقد بدأ الشعر الفصيح البروز في هذه البيئة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد توقف الدارسون عند بدايات شعر الفصحى بيد أن معظمهم تبع خُطا خالد سعود الزيد الذي رأى فـي قـدوم الشاعر عبدالجليل الطباطبائي (1776-1853) إلى الكويت عام 1843 واستقراره فيها بداية لذلك، حين افتتح به كتابه «أدباء الكويت في قرنين» في جزئه الأول الصادر عام 1967، ولكن خليفة الوقيان محص هذه المسألة ـ مسألة البداياتـ حيث رأى أن شعر الفصحى في الكويت أقدم من ذلك بكثير، كما شكك في قضية ريادة الطبطبائي وتأثيره فيمن حوله أو جاء بعده من الشعراء. وعرجت أمل عبدالله على المراحل الأخرى للحركة الشعرية في الكويت مستعرضة أهم النماذج في بعض المراحل وصولا الشكل الشعري الحديث في التجربة.
كما قدم الدكتور يوسف بن سليمان المعمري ورقة بعنوان قصيدة النثر العُمانية (سنواتٌ من الإنتاج الشعري)، «سماء عيسى نموذجًا» تناول فيها قصيدة النثر العمانية، وإلى دور الشعراء الثلاثة الأوائل في ريادة قصيدة النثر في عُمان وهم سماء عيسى وسيف الرحبي وزاهر الغافري، وإلى الشعراء الذين أتوا من بعدهم، ثم أضاء «المعمري» في ورقته بشكلٍ خاص إلى جوانبَ من تجربة سماء عيسى الشعرية، ودورها زمنيا وشعريا.
وقال: في بدايات نهضة عُمان الحديثة انتشى عدد من الشعراء لشباب، ليكتبوا قصائد مختلفة شملا وموسيقى عما جرت عليه الألسنة وتتذوقه الآذان، وتلذذت بنطقه الأسماع، وأقصد هنا القصيدة المعروفة والمسماة بقصيدة النثر .
. بغض النظر كيف بدأت تلك القصيدة مع أولئك الشعراء والأسباب التي أدت إلى ظهورها عندهم بالتحديد وليس عند غيرهم، لكنني أحسب أن تلك القصيدة الجديدة لم يتأخر ظهورها في عُمان مقارنة بطبيعة الشعر العماني العمودي السائد في ذلك الزمن وهو الشعر الذي حافظ عليه العمانيون زمنا طويلا وحتى قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحرة لم تخرج خروجا تاما من ثوب القصيدة العربية ذات الموسيقى الخليلية.
وأضاف: إذا ما أخذنا تجربة الشاعر سماء عيسى فبالإضافة إلى منشوراته في بداية السبعينيات المنشور في المجلات التي يذكرها بعض الباحثين في دراساتهم .. وعلى المستوى الفني جاءت قصيدة النثر عند سماء عيسى منسجمة مع بناء القصيدة النثرية، فهي قصيدة غامضة رامزة شديدة الكثافة، تصلح أن تقرأ في أي زمان ومكان لأنها قصيدة عابرة للأمكنة والأزمنة .. وقصيدة سماء عيسى مهمومة حزينة مليئة بالكآبة والأسى والقهر والموت .. باحثة عن الأحلام الضائعة وفيها بصيص من الأمل والرجاء.
وبعد الجلسة النقدية أقيمت أمسية شعرية بمشاركة الشعراء بدرية البدري وأشرف العاصمي، وشميسة النعمانية وإبراهيم السالمي، بالإضافة إلى محمد عبدالرحيم أحمد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونوف نبيل من مملكة البحرين وأحمد العمار من المملكة العربية السعودية.
وفي الختام كرّم الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العُماني المشاركين من النقّاد والشعراء المشاركين في جلسات المنتدى الثقافي الخليجي.
المصدر: الدستور