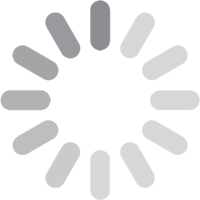أحمد زين الدين يستعيد فكر ميرسيا إلياد
يتناول كتاب «الديني والدنيوي: قراءة في فكر ميرسيا الياد» (دار بيسان) للباحث والكاتب اللبناني أحمد زين الدين أحد الوجوه اللامعة في حقل التاريخ الديني، هو المؤرخ والفيلسوف ميرسيا إلياد. وقد عرف القارئ العربي إلياد من خلال ترجمة بعض كتبه، علما أنّ أعمالاً ضخمة ومهمة له ما زالت غير مترجمة ضخمة الأخرى مثل «مصنّف في تاريخ الأديان» و «اليوغا» و «الموسوعة الدينية» غير مترجمة حتى اليوم.
باحث عربي، على حدّ اطلاعي، لم يتطرّق إلى دراسة منهجه الفكري، ولم تُحلّل نظرياته بالتفصيل. وإلياد تميّز بثقافته الموسوعية، وتفرّد بميوله نحو تاريخ الأديان الشرقية القديمة، وعُرف بنزعته الإنسانية، وإشادته بالثقافات البشرية النشيطة والحية، والإيمان بقدرة الديانات على خلق الاطمئنان في نفوس المؤمنين بها والذين ترعرعوا في أحضانها. وهو في هذا المجال ينتقد أولئك الحداثيين الذين يتعاملون مع الأساطير والميثولوجيات باستخفاف، لأنها في رأيهم، ناجمة عن رواسب لا عقلانية.
لذا فإنّ إلياد يدعو الإنسان المعاصر إلى الخروج من نطاق ثقافته المحدودة، إلى ثقافة كونية متكاملة ومنسجمة بعضها مع بعضها الآخر. وهو يشدّد على أنّ الأزمة الأوروبية هي أزمة ثقافة إقليمية، ويحثّ الأوروبي على أن يتفاعل مع سائر ثقافات البشر، خصوصاً القوى الروحية الشرقية، حتى يستطيع الغرب إيجاد توازن يحفظ صحة أبنائه النفسية. ولا يرى في الأديان أية حدود وفواصل بين الناس، إنما يرى فيها نسقاً ثقافياً جامعاً متعلقاً في حاجة البشر الأساسية إلى التفاعل فيما بينهم. ويعتقد أن بدايات أي ثقافة إنما تضرب جذورها في تجارب ومعتقدات دينية، وأن بعض الإبداعات الثقافية كالمؤسسات الاجتماعية والأفكار الأخلاقية بل والفنية، تظل بعد علمنتها مستعصية على الفهم السليم ما لم تُعرف أرومتها الدينية الأصيلة.
كما أنه يشير إلى الثراء الرمزي، والتركيب المعقّد، والفكر العميق للقدماء. ويؤكد بأن أي مجتمع لا يقوم دونما عقيدة أو إيمان، حتى ولو لم يكن ثمة إله أو آلهة ما، ما دامت الظاهرة المقدسة هي تجربة معاشة لقوة مفارقة ومتعالية داخل الإنسان الذي يحوّلها إلى بنية ثقافية ومؤسساتية ولسانية وسوسيولوجية شاملة.
يتناول إلياد الظواهر الدينية في كيفيتها الخاصة وشروطها التاريخية. فكلّ واقع ديني هو خبرة من نوع خاص ناجم عن لقاء الإنسان بالمقدس. وعليه فإنه يلقي الضوء على الوجه الرمزي والوجه الروحي والتماسك الداخلي في كل ظاهرة دينية، من خلال المقاربة الفينومينولوجية الظاهراتية لفهم جوهرها وبُناها. وفي اعتبار إلياد أنه لا وجود لحدث ديني محض خارج نطاق التاريخ وخارج نطاق الزمن. ومهما بلغت شمولية الظاهرة الدينية، فلا بد من أن تكون مشروطة بالمكان والزمان والثقافة السائدة التي ظهرت، أو وُلدت في أحضانها، ومتوافقة مع تركيبة المجتمع الزمنية، وأوضاعه الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تسود فيها.
وفي معظم ما كتبه إلياد إنما حاول أن يضع إصبعه على أزمة المعنى الوجودي عند الإنسان المعاصر، لا سيما الغربي الذي تقطّعت سُبُل تواصله مع العالم القديم. وهذه الأزمة التي أصابته كانت حصيلة سيرورة العقلنة التي تبنتها المجتمعات الغربية في العصر الحديث، لا سيما غياب البُعد المتعالي. وكان من نتائج الخروج عن الدين، أو غياب الدين عن أفق الإنسان، وما استتبعه من إبطال صفة القداسة، أن تزعزعت العلاقة بين الإنسان وذاته فاضطر إلى اختلاق أواصر بديلة.
يرى إلياد أن الإنسان الحالي الدنيوي يحاول، وهو المُستغرق في التاريخ المدني، أن يدفن الرجل الديني الموجود على عتبات لاوعيه، والمُشرّب بالرموز والنماذج الأصلية. وعلى رغم تعاطفه مع الرجل المتديّن، فإنه يرى إلى أنّ الدنيوي يعيش الأزمات الوجودية ذاتها، إلاّ أن الدين يقدّم حلولاً لا يمتلكها الدنيوي. وليس معنى هذا أن إلياد يطالب بالتحرّر من التقنيات الحديثة وإفرازاتها، أو التخلّص من الموروث الإنساني الضخم الذي راكمته هذه التقنيات، إنما السعي إلى إيجاد علائق جديدة تُخرجه من حالة السُبات الروحي التي يغرق فيها.
وما تتميز به منهجية ميرسيا إلياد هي عكوفه على تحليل العلاقة بين الرموز وتجلياتها الدينية. إذ الرموز عنده ليست علامات تعسفية معلقة في الفراغ، ولا حرتقات صبيانية يتصف بها عادة «المنطق» البدائي. فالديني بدائياً كان أم متمدناً، يفكر، كما يرى إلياد، بواسطة الرموز. والرموز مهما تكن طبيعتها أو مستواها هي دائماً متماسكة متعاضدة، حتى في أقصى حالات تدهورها. فلا نكتشف مثلاً العلاقة بين الطوفان، والمعمودية، وإراقة الخمر، والتطهّر بالماء، والرؤى الأخروية إلاّ في ضوء رمزية أوسع هي الرمزية المائية.
يتناول إلياد البنيات الأولية ذات الترسبات الميثولوجية التي ارتكزت عليها الأديان القديمة، ولم تُستثنَ منها الأديان التوحيدية الأحدث ظهوراً، والتي استصلحت الاقتصاد الروحي، وعملت على إعطائه بُعداً مسكونياً عالمياً.
ولا تزعم هذه الدراسة أنها أحاطت بشمولية إنتاجه ومنهجه ومساره الفكري، إنما سعت إلى إنارة بعض النواحي الأساسية التي تجلي مقاربته للظاهرة الدينية الشديدة التعقيد، وظروف تشكّلها وتفكيك رموزها.
ولد المؤرخ الديني والفيلسوف والروائي ميرسيا إلياد في مدينة بوخارست، عاصمة رومانيا، في 13 آذار عام 1907، وتوفي في 22 نيسان 1986. أتقن إلى جانب لغته الأم عدة لغات من بينها: الفرنسية والألمانية والإيطالية والإنكليزية. كما ألمّ بالعبرية والفارسية والسنسكريتية. ودوّن الجزء الواسع من عمله الأكاديمي بالرومانية ثم الفرنسية فالإنكليزية.
كان مفتوناً بعالم الطبيعة الذي شكّل الإطار الوصفي لأولى تجاربه الأدبية الروائية. وأُعجب أيضاً بالفولكلور الروماني، وبالديانة المسيحية الشعبية التي يعتنقها الفلاحون البسطاء ويمارسون طقوسها.
كما اطلع على قصائد سعدي الشيرازي وملحمة غلغامش، واهتم بالفلسفة، ومن فلاسفته المميزين سقراط، وماركوس أوريليوس الإمبراطور وأحد أعمدة الفكر الرواقي.
يُعدّ ميرسيا إلياد واحداً من المبرّزين في كتابة التاريخ الحديث للأديان. وهو من الباحثين القلائل المواظبين على دراسة الأساطير. وقد ساهم في وضع علوم الأديان المقارنة، مبيناً علاقة تقارب بين مختلف الثقافات، والأوضاع الاجتماعية والتاريخية والنفسية. وأفضى تكوينه الفلسفي والتاريخي إلى دراسة الأساطير والأحلام والرؤى والتصوف.
ويميز إلياد بين اتجاهين في تاريخ الأديان: الأول هو الاتجاه الهرمينوطيقي التأويلي عند أولئك الذين يعتقدون أن علينا فهم دلالة أي ظاهرة من خلال اجتهادنا واستيعابنا. والاتجاه الآخر بنيوي يحتذيه كلود ليفي ستروس الذي لا يؤمن بإمكان فهم أي ظاهرة من خلال أنفسنا، بل من خلال ظهورها الموضوعي. لكنّ إلياد يرى أن مؤرخ الأديان، مهما كانت عقيدته، عليه إدراك المعنى الأصلي لظاهرة المقدس، وذلك بمراقبة تحوّلاتها، ومعنى هذه التحوّلات.
يأتي كتاب «الديني والدنيوي» لأحمد زين الدين بعد أعمال فكرية عديدة منها: «الحداثة ويقظة المقدّس» و «أصوات سردية» عن دار بيسان أيضاً، إضافة إلى أبحاث ومقالات نقدية منشورة في الدوريات والصحف العربية.