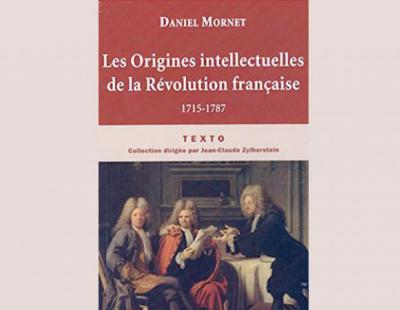لماذا شكلت الثورة الفرنسية قطيعة كبرى وربيعا حقيقيا؟
غني عن القول أن الثورة الفرنسية تمثل ذلك الحدث الضخم الذي دشن العصور الحديثة، وأحدث القطيعة مع العصور الوسطى الأصولية الإقطاعية. بهذا المعنى، فهي تمثل ربيعاً حقيقياً، على الرغم من كل الآلام والدماء والمخاضات العسيرة التي رافقتها. فقد تمخضت في نهاية المطاف عن نظام جديد يساوي بين المواطنين جميعاً، أياً تكن انتماءاتهم الدينية والمذهبية. بهذا المعنى، فقد شكلت قطيعة مطلقة مع الماضي المذهبي أو الطائفي لفرنسا، عندما أعطت الأقلية البروتستانتية حقوقها كاملة، ولم تعد تحتقرها أو تزندقها أو تكفرها. لقد انتهى عهد الاضطهاد والاحتقار، وحل محله عهد جديد قائم على احترام الكرامة الإنسانية لأي شخص، أياً يكن دينه أو طائفته. هذا هو الربيع الحقيقي، ربيع الشعوب والكرامة الإنسانية المتساوية للجميع. وهكذا تكون الثورات أو لا تكون! ولكن ما كان ذلك ممكناً لولا أن عصر التنوير الكبير كان قد سبقها واحتضنها ومهد لها الطريق. وهذا ما يشرحه لنا بالتفصيل البروفسور دانييل مورنيه في كتاب ضخم أصبح كلاسيكياً الآن، بعنوان: «الأصول الفكرية للثورة الفرنسية». ونفهم منه، ومن مصادر أخرى، أنه لولا جهود فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو وديدرو، والموسوعيين عموماً، لما نجحت الثورة الفرنسية. كل اللاهوت المسيحي الظلامي القديم وفتاواه التكفيرية وتمييزاته الطائفية أسقطها هؤلاء المفكرون الأفذاذ. ولذلك من يقول لك متهكماً إن كتابات المثقفين عبارة عن ثرثرات مجانية تضيع في الفراغ مخطئ تماماً، فالفكرة إذا كانت صائبة أو صحيحة أقوى من الرصاصة، وتحفر عميقاً في الأرض؛ كتاب واحد قد يغير مجرى التاريخ، وهو الكتاب الذي يستعصي حتى الآن على العالم العربي. ينبغي أن نتموضع في ذلك العصر لكي نعرف معنى الحدث التحريري الهائل الذي شكله ظهور كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو، أو كتاب رسالة في التسامح لفولتير، أو كتاب روح القوانين لمونتسكيو... إلخ. وهنا، نلمس لمس اليد تلك العلاقة الجوهرية، وأكاد أقول الكيميائية السحرية التي تربط بين التغيير الفكري والتغيير السياسي.
واللافت أنها تحققت خلال بضعة أشهر فقط من 17 يونيو (حزيران) إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1789. ولكنها ابتدأت في الواقع منذ الخامس من شهر مايو (أيار) من العام نفسه. نقول ذلك على الرغم من أنه لم يحصل أي حدث ثوري عنيف في ذلك اليوم. فالملك لويس السادس عشر كان قد دعا ممثلي الأمة الفرنسية للاجتماع في قصر فرساي في ذلك اليوم بالذات من أجل التناقش بشأن الإصلاحات، ولكنه ما كان يعلم أن الثورة الفرنسية ستندلع بعد بضعة أسابيع لكي تطيح به، وبكل عائلته التي حكمت البلاد على مدار القرون.
والواقع أن الشخصيات التي دعيت للاجتماع في ذلك اليوم المشهود كانت تنتمي إلى الطبقات الثلاث التي تشكل الشعب الفرنسي: أي طبقة الكهنة وكبار رجال الدين، ثم طبقة النبلاء الأرستقراطيين الإقطاعيين، ثم طبقة بقية الشعب: أي معظم سكان فرنسا. الطبقتان الأوليان كانتا تتمتعان بامتيازات ضخمة، مادية ومعنوية، في حين أن الشعب كان يرزح تحت نير العبودية والفقر، وذلك لأنه كان يكفي آنذاك أن تولد في عائلة نبلاء أو عائلة من كبار الكهنة المسيحيين لكي تفتح أمامك أبواب الدولة والتوظيف والثروة على مصراعيها. أما إذا شاء لك الحظ العاثر أن تولد في طبقة شعبية أو فلاحية، فالويل لك. وكان معظم أبناء الشعب الفرنسي آنذاك خدماً عند الكهنة والطبقة الأرستقراطية.
وضد هذا الوضع المهين واللاإنساني اندلعت الثورة الفرنسية، وبالتالي فقد كانت ثورة من أجل العدالة والحرية بالدرجة الأولى. وقد افتتح الاجتماع المهيب مطران مدينة نانسي «لافار»، وهاجم في خطابه أخطاء فلاسفة التنوير وترف البلاط الملكي في آن معاً، وقارن بينه وبين فقر الفلاحين في الأرياف الفرنسية، وقال ما معناه: لا يجوز أن يكون الغنى الفاحش في جهة الأقلية، والفقر الفاحش في جهة الأكثرية.
ومعلوم أن ممثلي الفلاحين والطبقات العمالية والشعبية كانوا قد أسمعوا صوتهم في القصر بهذا الاتجاه، وقالوا للملك إن الشعب يتضور جوعاً لأن الضرائب أثقلت كاهله، ثم قالوا للملك: إن الشعب يدفع كل شيء، وأما الكبار - أي الأغنياء جداً - فلا يدفعون شيئاً للخزينة العامة، فهل هذا معقول يا جلالة الملك؟ هل يعقل أن يدفع الفقير الضرائب ولا يدفعها الغني الفاحش الثراء؟ هكذا، نلاحظ أن الثورات تندلع بسبب أعمال الظلم والقهر. فإذا ما تفاقمت وزادت عن حدها، لم يبقَ إلا الانفجار، فهل يسمع السامعون؟ هل يتعظ المتعظون قبل فوات الأوان؟
والآن، نطرح هذا السؤال: كم كان عدد النبلاء الأرستقراطيين في فرنسا آنذاك؟ والجواب هو التالي: نحو الثلاثمائة ألف شخص في بلد يصل عدد سكانه إلى الثلاثين مليون نسمة تقريباً. كل الشعب كان يخدم هؤلاء النبلاء الإقطاعيين الذين يتوارثون الامتيازات والمناصب أباً عن جد. وضد هؤلاء اندلعت الثورة الفرنسية التي رفعت الشعار التالي: حرية، مساواة، إخاء. بمعنى أنه لا يوجد بعد اليوم ابن ست وابن جارية، وإنما يوجد شعب واحد مؤلف من مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
ولكن الثورة اندلعت أيضاً ضد طبقة رجال الدين التي كانت تستغل الشعب مثل طبقة النبلاء، وإن بطريقة أخرى. فقد كانت تخدّره بالمواعظ المسيحية التي تطلب منه القبول بواقعه البائس مقابل الوصول إلى الجنة في العالم الآخر. بمعنى آخر: إذا كان يعيش في الجحيم في هذا العالم، فلا ضير في ذلك، لأن مصيره سيكون الجنة بعد الموت. وبالتالي، فهنيئاً له. لقد لعب رجال الدين دور الدعاية الديماغوغية للعهد القديم، عندما أقنعوا الشعب بعدم الثورة عليه. وكانوا يلحون في مواعظهم يوم الأحد على الفكرة التالية: إن الثورة على الحاكم تعني الثورة على الله ذاته، لأن ملك فرنسا هو ظل الله على الأرض.
ولكن بما أن الفلاسفة كانوا قد نقضوا هذه الفكرة من قبل وفككوها، فإن الشعب المستنير، وخصوصاً في المدن، راح يتجرأ على إعلان غضبه الشديد على الوضع القائم. ومعلوم أن جان جاك روسو، أحد ملهمي الثورة الفرنسية، كان قد ركّز على الفكرة التالية: وهي أن الناس خلقوا متساوين في البداية، ثم اختلفت أوضاعهم بعدئذ، وانقسموا إلى فئتين متمايزتين: فئة النبلاء والأغنياء المالكين للأرض، وفئة الفلاحين الفقراء الذين يشتغلون في الأرض دون أن يملكوا شيئاً.
وبالتالي، فالملكية هي أساس التفاوت بين البشر، وهي التي أدت إلى كل هذا الظلم الذي أصاب الفلاحين الذين يشكلون أغلبية الشعب الفرنسي. وفي خطابه الشهير عن أصل الظلم واللامساواة بين البشر، فكك روسو كل الأفكار القديمة التي تبرر الامتيازات والتفاوتات الطبقية، وقال إنه لا أصل لها ولا شرعية على الإطلاق.
وكان هذا الخطاب بمثابة إعلان حالة حرب على النظام القائم، حتى قبل أن تندلع الثورة الفرنسية بثلاثين سنة على الأقل. وبالتالي، ففلاسفة الأنوار كانوا قد مهدوا الأرضية، وزرعوا البذور الفكرية التي تفتحت لاحقاً، وأدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية.
فالثورة لم تنشأ من العدم، أو لم تكن ممكنة لولا أن المشروعية القديمة التي تبرر الامتيازات والتجاوزات قد سقطت، أو أصيبت في الصميم، وحلت محلها مشروعية جديدة هي مشروعية حقوق الإنسان والمواطن. والواقع أن الشرعية الإلهية الكهنوتية للملك لويس السادس عشر كانت قد سقطت في نظر قادة الثورة والطبقات البورجوازية المستنيرة من الشعب، ولكنها كانت لا تزال قوية في نظر غالبية الفلاحين الفقراء الذين يعتقدون أن الملك الفرنسي هو بالفعل ظل الله على الأرض.
على أي حال، لا يمكن فهم سبب اندلاع الثورة الفرنسية إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تختمر أو تعتمل في أعماق فرنسا منذ عقود كثيرة من السنين. فالبلاد كانت جائعة تقريباً، أو قل إن القسم الأكبر من الشعب كان جائعاً، في حين أن النبلاء والكهنة والأغنياء كانوا يعيشون حياة البذخ والإسراف في القصور؛ عنيت الكهنة الكبار، وليس معظم رجال الدين العاديين الذين بقوا فقراء مثل الشعب. وهذا هو السبب الأساسي لاندلاع الثورة الفرنسية في الواقع. وهذا ما لم يفهمه لويس السادس عشر إلا بشكل متأخر وبعد فوات الأوان. نقول ذلك خصوصاً أن حاشيته أو بطانته أخفت عنه حقيقة الصورة. وزاد من تفاقم الأوضاع سوء المحاصيل الزراعية في العام الذي سبق الثورة مباشرة، أي عام 1788. وهكذا، أصبح القمح نادراً، وبالتالي فلم يعد هناك خبز أو طعام. ومعلوم أن الخبز هو المادة الأساسية للشعب. وعندما يجوع الإنسان، يثور أو يصبح ميالاً للتمرد على النظام القائم. فالجوع كافر لا يرحم.
ولكن بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التحدث عن أزمة الثقافة السياسية في فرنسا آنذاك. فالشعب لم يعد يقدس شخص ملوك فرنسا، كما كان يحصل سابقاً، أو قل أصبح يقدسهم بشكل أقل. وتأثير الكهنة ورجال الدين لم يعد قوياً، كما كان عليه الحال في العصور الماضية، وذلك لأن الأفكار الثورية والتنويرية كانت قد انتشرت في صفوف الشعب، وتغلغلت بما فيه الكفاية. وأما الطبقة البورجوازية الصاعدة، فكانت قد تخلصت كلياً من الأفكار القديمة التي تخلع القدسية على النظام السائد. وكانت أفكار فلاسفة التنوير قد انتشرت في صفوفها وتغلغلت إلى أعماقها، وبالتالي لم تعد تشعر بالمهابة أمام النبلاء الأرستقراطيين كما كان يحصل سابقاً، وهذا ما دفع بها إلى الثورة عليهم وبكل حقد أحياناً لأنهم مصّوا دم الشعب، وتمتعوا بخيراته وعرق جبينه، على مدار القرون.
ضمن هذه الأجواء، ينبغي أن نموضع الأمور لكي نفهم سبب اندلاع الثورة الفرنسية التي كانت نتيجتها تجديد البلاد، والخروج من الروتين ومستنقع الجمود والركود. لا ريب في أن الثورة تهدم وتدمر، ولكنها تبني وتعمر أيضاً على أنقاض الدمار. علاوة على ذلك، فإنها تدخل حيوية جديدة إلى البلاد، وتفتح آفاقاً واسعة لم تكن في الحسبان، وهذا ما يؤدي إلى تجديد الطاقات وشحذها من جديد. أما استمرارية الوضع القائم على ما هو عليه، وكل ما يرافق ذلك من انسداد وتعفن، فإنه يعرقل الانطلاقة ويخنق الحيوية والطاقات الجديدة التي تريد أن تعبر عن نفسها. بهذا المعنى، فإن الثورة الفرنسية كانت حظاً لفرنسا، على الرغم من كل شيء. لقد أدت إلى ولادة فرنسا جديدة، فرنسا حيوية مليئة بالنشاط والأمل، فرنسا مختلفة عن فرنسا القديمة الجامدة التي وصلت إلى الجدار المسدود. وبالتالي، فقد ماتت فرنسا لكي تحيا فرنسا! فهناك الطرق أو الآفاق الجديدة التي دشنتها الثورة الفرنسية، وكيف أنها غيّرت العلاقة بين الدين والسياسة، أو بين الشعب والحكم، أو بين الأغنياء والفقراء.