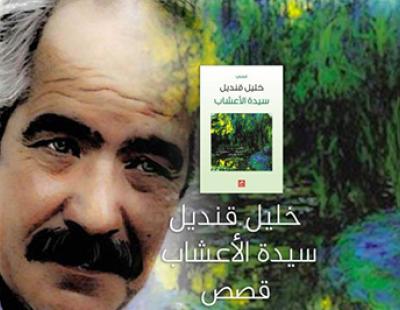«سيدة الأعشاب» وتقنية المشهد السردي المفتوح
ما الذي يعنيه صدور هذه المجموعة «سيدة الأعشاب» لخليل قنديل -الراحل العزيز الذي فقدناه- في عداد الكتب المدعومة من وزارة الثقافة، ومنح التفرغ الإبداعي، إن لم يكن الدعوة مجددًا لاستمرار العمل بهذه المنح التي تعطي المبدعين فرصا لإجادة ما يكتبون.. في مأمن من إلحاح متطلبات الحياة اليومية، التي تشغل المبدع غالبًا عن إبداعه، وتشتت اهتماماته في أنحاء شتى، تؤثر تأثيرًا سلبيًا على ما يكتب.
تموزُ البابليّ
ففي هذه المجموعة سيدة الأعشاب يتجاوز خليل قنديل جل ما كان يؤخذ عليه في قصص سابقة مثل وشم الحذاء الثقيل، وحالات النهار، وعين تموز، ليقدم لنا كتابة جديدة شكلا وفحوىً. فمن يقرأ قصته الأولى الموسومة بعنوان «السبعيني» يجد نفسه أمام قصة ذات بناء فني شديد التماسك، تسهم كل عبارة فيه، وكل جملة، في تحقيق التسلسل المشهدي السردي. فبطل القصة- وهو الراوي هنا- يفيق في منتصف شهر كانون الثاني من كل سنة ليطل من نافذة البيت الذي استأجره منذ خمس سنوات في جبل اللويبدة، على حديقته المنزلية، وهي حديقة صغيرة جدًا، لكن الأشجار، والنباتات المنزلية، تتكدس فيها بطريقة لافتة للنظر. وما يستدعي السارد- ها هنا - لتذكر المشهد هو تغيّب المزارع (السبعيني) الذي اعتاد أن يأتي في كل سنة مرة واحدة ليعنى بالدالية، وشجرة اللوز، والتينة، والليمونة الشهرية، والورد الجوري، فيقلم، ويشذب، ويسمّد تارة، ويزرع ويقلَع تارة أخرى، فيحيل الحديقة الشعثاء إلى مشهد يبهج العين، ويسرُّ القلب.
أما الحوار، الذي يستذكره الراوي العليم بين الرجل- صاحب البيت - و»السبعيني» الذي يرفضُ التقاعد من عمله هذا، فينم عن إصرار هذا الإنسان على بعث الحياة، والتجدد، فيما هو مهدد بالذبول، واليُبْس. وبعث الحلاوة فيما هو مؤذن بالكزازة، والمرارة. وبعث الخصوبة فيما هو مؤذن بالعقم، والجفاف. هو تموزُ- إذاً- الذي نعرفه في أساطير بابل وآشور، ومع أنه لا يتقاضى مقابل العمل الذي يقوم به إلا القليل جدا(ديناران حسب)إلا أن لذته بهذا العمل لا تعادلها لذة أخرى، ولا حتى لذاذة الكسل التي ينعم بها مستخدمه في هذه القصة، وهو صاحب البيت.
يسلط الراوي الضوء على علاقة هذا السبعيني بالتربة، بالتينة، بالنباتات الكثيرة المتسلقة، أو الممتدة على الأرض، هذا الفلاح البسيط متمسك بالحياة؛ فلا يسره شيء قدر سروره في أن يقال عن يده: «يدُه خَضْرَة» أو خضراء، فلا فرق. أي أن تأثيره يأتي بالنتائج المرجوة دائمًا على الرغم من أنه، هو، آيل للتداعي الذي تنبئ عنه ملامح شيخوخته الظالمة، التي أدت إلى تغيبه عن الحديقة في هذا العام، وهو العام الذي كتبت فيه القصة، أي العام الذي روى فيه الراوي حكايته.
ومنْ يقرأ هذه القصة ثانية، يلاحظْ حرصَ الكاتب، من البداية، على تقسيمها إلى مشاهد يتكرر في مطلع كل منها لفظ «الرجل»، معلقا كلا منها بالمشهد الذي قبله، والمشهد الذي يليه. فكل منها مفتوح على الذي قبله والذي بعده. فهي مشاهد سردية تتفاعل، وتنفتح على أفق يمتد، مؤديًا إلى نهاية معينة :» حينما أزحت الستائر.. توجّهتُ بنظراتي إلى شجرة التين التي زرعها.. أدهشني اللون العظمي المزرقّ لأغصانها العارية مثلما أدهشني البرْق الذي لمع فجأة في السماء.. راسماً لي - وفوق شجرة التين بالذات – ما يشبه ُاليدَ الخضراء».
وهذه النهاية تشبه- في اعتقادنا- الرؤيا، أو الحلُم الذي كان ينْبغي أنْ يُسْتوحى من عنوان القصة. فلوْ جعل خليل قنديل قصته هذه قصة بعنوان: «اليد الخضراء»أو الخضرة، أو» يدٌ خضراءُ» لكان حظه من التوفيق، ومن مطابقة العنوان للفحوى، وملاءمة الدال للمدلول، أبينُ، وأظهر، من «السبعيني»؛لأنّ كلمة «السبعيني» وإنْ كانت تلفت النظر بطابعها المكثَّف – وهو شيءٌ يحرص عليه المؤلف - فيما يبدو من عنوانات قصصه في الكتاب: «البيت»، «السبعيني»، «المزيونة»، «الطاسة»، «المنديل»، «الرحيل»، «الدرويش»، إلخ.. فيدٌ خضراء عنوان أكثر تشويقا من السبعيني، ويساعد على ربط بداية القصة بالخاتمة، جاعلا من السرد سرداً دائريًا يشحذ الانتباه نحو وجهة النظر التي يعبر عنها الكاتب.
تأويلُ اللَّوْن
فاللون- والكاتب يكثر في هذه القصة من ذكر الألوان- العَظْميّ، الضارب للزرقة، دالّ لدى بعض الناس على الذبول، واليُبْس. وربما الموت. وقد لا يكون الأمر كذلك لأن الوقت الذي تقع فيه أحداث هذا المشهد هو فصل الشتاء، وفيه تكون شجرة التين عارية من الأوراق تكاد تبدو لمن يراها ميتة ضاربة إلى السواد، فضلا عن الزرقة التي توحي بالموت. وقد أضاف الراوي لذلك المشهد رؤية البرق، وهو مشهد يتكرر ذكره في آداب الشعوب، وفي آداب العرب. وتأويل ذكره: قدوم الغيث، وسيدة الأمطار، أو الأعشاب، ومجيء الرعد، وما يصاحب ذلك كله من استدعاء للذكريات» وأومض البرق في الظلماء من إضم ِ» و»صاح ترى برقا يُريك وميضه « وفي ضباب هذا المشهد الكوْنيّ تلوح تلك «اليد الخضراء» فيرى القارئ نفسه أمام لوحة تتوزع فيها الملامح والألوان. وباستخدام الراوي كلمة «راسماً» وعبارة :»فوق شجرة التين بالذات» ما يوحي بأن «السبعيني» استحالَ في هذه القصة طيفًا. وبذلك يترك الكاتب للقارئ مساحة أكبر لملء الفجوة، وسدّ الفراغ مستدركا بنية الحكاية بما سماه ديريدا تكملة.
صاحب اليد الخضراء، ذو السبعين عاماً، الذي لا يطيق صبرًا على القعود في بيته من غير عمل، الذي يعشق التربة، والشجرة، ويرى في حياتيهما المتجددة، الندية، المخضوضرة، النضرة، استمرار حياته هو، قد رحل هو الآخر، لتبقى ذكراه ماثلة في هاتيك الأغصان التي تبرْعِمُ - بلا ريب - كلما عاد الربيع.
ومثلما يُلاحظ القارئ تروي هذه القصة حكاية قصيرة، فيها شخصيّة (السبعيني)وراو ٍ(صاحب المنزل) ومكان(المنزل، والحديقة) وفضاء قصصي :اللويبدة، السلط، حيث مكان إقامة السبعيني، وقدومه المتكرِّر منها إلى عمان. والأجواء التي تكتنف الحدث. وعقدةٌ، هي: غياب السبعيني. ومشهدٌ يتفتت إلى مشاهد بعضها مفتوح على بعضها الآخر. ولغة تتكدس فيها، وفي نسيجها اللفظي، الإشارات: لونية تارة، وبصرية تارة أخرى، وحسية ذوقية، ومع ما فيها- أي القصة- من مكونات سردية، إلا أنها تقترب أيضا من القصيدة. ولعل أوضح ما يقرّبها من الشعر هو عزوفها عن البوح بوجهة النظر، أو الفكرة التي يعبّرُ عنها الكاتب، والتوجّه للإيحاء بها بدلا من البوح، والترميز عوضا عن التصريح، وتضمين الحكاية نصًّا غائبا له ظلال واضحة في النسيج السَّردي، وهو أسطورة تموز، الذي يعيد الحياة للطبيعة بعد جفاف. وهذا جله، إنْ لم يكن كله، من مسوِّمات الخطاب الشعري الذي تلتقي فيه القصة بـ «سيماء» القصيدة.
المشهد السرْدي
ومنْ يَعُدْ للقصة الأولى في «سيدة الأعشاب» يلاحظ تكرير الكاتب كلمة»الرجل» في مستهل كل مشهد سردي. وهذا قد يلقي الضوء على توجه أسلوبي في كتابة القصة استعير من القصيدة القصيرة، ويقوم على استخدام تقنية المشهد السردي. وتنبني القصة بالتحام هذه المشاهد بوسيط هو الشيء الذي يتكرر ذكره عادة أكثر من تكرير غيره.وهذا يذكرنا بسمة لافتة في الشعر وهي قيامه على إيقاع التكرار فيما تقوم القصة على إيقاع الاستمرار والاطراد، فيما يؤكد، ويلح نورثروب فراي.
ففي قصة «السبعيني» لاحظنا هذه الظاهرة، وتكراره كلمة»السبعيني» لكنها سرعان ما تختفي في قصص أخرى.
نجدُ - على أي حال - في قصة «البيت» غموضاً نراه محبباً لدى القارئ، فالرجل الذي جاء إلى جبل الجوفة في عمان باحثا عن بيت معين يشتريه، ويرممه، ويقيم فيه، رجل غامض بلا ريب، بدليل أن الخريطة التي لديه خريطة بمواقع معينة، وهو يبحثُ عن بيْتٍ معيّن لشرائه، هو بالذات، لا عن أيّ بيت، وحين يبصر بيتا تلوح عليه إمارات التداعي، يطلب من السائق التوقف، فقد وجد ضالته المنشودة، وبغيته المفقودة، في ذلك المبنى العتيق، متهرئ الجدران. وهو بيت من أوائل البيوت التي شيدت في ذلك المكان. وقد ارتبط وجوده بذكريات مرعبة، فبعد عامين حسبُ من تشييده سقطت ابنة الرجل الذي بناه من على الجدار المطل على المدرج الروماني، وفقدت حياتها على الفور. والشائعات عن كثرة الأرواح الشريرة التي تقيم فيه لم تعد شائعات، بعد أن تأكد أن ما يقال عن أفعال هاتيك الأرواح وقائع حدثت، ولا تقبل النفي. وسرعان ما تكثر التأويلات التي يتداولها الناس عن البيت، فبعضهم يزعم أنه شيد فوق ضريح وليّ صالح، وأن روح هذا الولي تنهضُ في الظلام، وتنبعث، وتتجوّل في البيوت المجاورة، وفي أرجاء الحي، ولذلك سبب في الشؤم الملتصق به، وبمن يقيمون فيه، وكأنّ الولي الصالح غير راض ٍعن بنائه فوق ضريحه. وعدما حاول أحد الفقراء المستخفين بالجنّ الإقامة فيه، لم يستطع البقاء إلا ليلة واحدة لهول ما رأى، وما سمع، هو، وأولاده.
ومع ذلك لا يلقي الرجل الذي يتكرر ذكره في رأس كل مشهد سردي بالا لكل ما يقال، أو يُشاع عن البيت، ولا لتلك الروائح العطنة التي تستقبله كلما اجتاز العتبة المتآكلة؛فقد عزم على ابتياع البيت، وترميمه، وتجديده، وزرْع حديقته بالأشجار الحرجيّة، والمثمرة، والورود، وتنظيف حجارته ذات الألوان الباهتة، وقرميده، وإعادة دورة الكهرباء والمياه إلى المبنى. وفي أقلَّ من عشرة أيام اهتزّ حلالها جبل الجوفة على إيقاع المفاجأة، شعر الناس بإثم غامض بسبب هاتيك الأوهام التي أسقطوها على البيت.
ولكنْ، لم يكدْ يمضي على إقامة الرجل فيه عام كاملٌ، حتى اندلع فيه حريق أتى على كل شيء: من شجر، ومن حجر، ومن أناس، ودامت رائحة الحريق فيه مدة طويلة، وقيل: إنّ السبب هو تماسٌّ كهربيّ. وقيلت أسباب أخرى. وفي هذه القصة يظهر أحد الأشخاص سماه الراوي «أبو يحيى» وأبو يحيى هذا صاحب البقالة الوحيدة التي تقع قبالة باب البيت. ولديه ، بسبب هذا الموقع، الكثير من الأخبار، والأسرار، التي قيلت، وتقالُ عما يحيط بالبيت، وبمن بناه ، ومن أقام فيه في السابق، ومن اشتراهُ، وجدَّده، في اللاحق.
وأبو يحيى هذا يتكرر ذكره، مثلما يتكرر ذكر الرجل، في مشهدين سرديّين، أولهما أعقب قدوم الرجل صاحب الخريطة، وثانيهما بعد أن ابتلع الحريق المكان بما فيه ، وتركه كتلة متفحمة تزكم بروائحها الأنوف. وهذا الرجل، هو، وحده، الذي يرفض تصديق ما يقال عن التماس الكهربي. فقد حاول - بنفسه - أن يعرف الحقيقة، فتسلق السور المفضي إلى المدرج الرومانيّ، وسقف السيل، أي: السور نفسه الذي سقطت عنه ابنة منشئ البيت، فماذا رأى؟ «فتاة ممشوقة، بيضاء، تسير في الغبش الفجْري، مُلوِّحة له بإيشارب أبيض، بينما راح وجهها يطفح بالبهجة.»
وهذه الرؤيا، التي يراها أبو يحيى، لا فيما يراه النائم، بل فيما يراه اليقظان، كأنما جاءت لتؤكد أن ما كان يشيع عن البيت لا يتجاوز الحقائق. فهل الفتاة المبتهجة بحريق المنزل هي الفتاة نفسها التي سقطت عن السور عند بنائه، وتوفيت فوراً، فكانت سببا للشؤم اللاصق بالبيت منذ ذلك الحين، والتطيّر الذي جعل الذاكرة الشعبية تنسج حوله الكثير من الحكايات التي تصدق ولا تصدق؟ أهي التي أسهمت في إحراق المنزل، وأسلاك الكهرباء بريئة مما ينسب إليها براءة الذئب من دم يوسف؟أم أنّ الرجل الذي قيل إنه تفحم هو الآخر فيما تفحم له يد في الحريق؟
حوافزُ الغُموض
هذه الأسئلة – في اعتقادنا- تضيف إلى حكاية «البيت» حكاية جديدة أحسب القارئ مطالباً بشحذ تصوراته حول الحدث بدايًة، ونهايًة، ومغزىً. فهي - بلا ريب - كالقصة التي نوهت إليها في السابق، تطفو على تيار من الإيحاءات، والمبادرات الرمزية. فهل كان اختيار المؤلف لجبل الجوفة موقعًا للبيت اختيارًا عشوائياً، لا يعدو أن يكون ملحقا بالحدث الأول المقترن ببناء البيت؟ وهل ذكرُه الخريطة التي استلها الرجل من جيب سرواله محدداً اختياره لهذا البيت بناء عليها، ذكرٌ عشوائي؟ وهل أراد هذا الرجل من شراء البيت العثور على كنز، أم اقتناص مركز السيادة، والقيادة في الحي؟ وهل في رؤية شبح الفتاة أضغاثُ أحلام، في يقظة لا في منام، رؤية عشوائية لا أكثر؟
جلّ هذه الأسئلة، يُضفي على هذه القصة غموضا يشجّع القارئ المتبصّر على التأمل، والتصور، والتفكير. صحيحٌ أنّ بعض الناس لا يتمتعون بقراءة هذا اللون من ألوان القصص، ويفضلون القصة التي تمنح نفسها للقارئ من التجْربة الأولى، ولا يميلون للقصة اللعوب، التي تراوغ، وتتأبّى على الفهم من النظرة-القراءة- الأولى، ولكنّ قنديلا في هذه القصة بالذات يتجه إلى النوع الأول الذي يهتمّ بالدفين، والمخبوء، بالمحذوف والمضمر، أكثر مما يهتم بالملفوظ والمعلن.
زيْنٌ ومَنْدَل
ولو أنّ الكاتب خليل قنديل وسم قصته «المزيونة» بعنوان «المندل» لما كان مخطئاً. ولكنه بلا ريب أحبَّ التحريف الشائع في كلمة «زين»وهو اسم الفتاة، التي اختفت عن الأنظار أياما قضّت خلالها مضاجع الأهل: الأم، والأب، والإخوة، والجارات، والجيران، وحتى رجال الشرطة الذين أبلوا بلاءً حسنا في البحث عنها. لكنّ القصة الحقيقية اتخذت مساراً آخر في الحكاية، المكتوبة، فقد بالغ الراوي كثيرا في نعت الفتاة حتى أصبحت في نظرنا نموذجا لا للبراءة حسب، بل للجمال، والملاحة، على وجه التدقيق.
وليت الأمر يقف عند هذا، فالراوي بالغ أيضاً في جعل الفتاة الصغيرة تؤدي دور العروس، في لعبة «عروس وعريس» التي يزاولها الأطفال في الحيّ، ومن سوء حظّ الصبيّ هاشم الذي قام بدور العريس، أن تختفي بعد الذي عاناه من تلك الدغدغة النادرة التي أحس بها في جسده وهما يجلسان ملتصقين على صخرة ناتئة فيما كان الآخرون يطلقون الزغاريد وكأنهم في عرس حقيقي. وعندما أجمع الأهل على الاستعانة بالشيخ سليمان المغربي، الذي يستطيع البحث عن» مزيونة» بوساطة «المَنْدل» وهو نوع غامض ٌ من الشعوذة، يزْعُمُ الزاعمون أن التائه، الضائع، من إنسان ومن حيوان، يُرى في صفحة الإناء النحاسي المملوء بزيت الزيتون، والماء. ويشترط في العادة أنْ ينظر في الإناء شخصٌ بريء، طاهرٌ، ونقيّ السريرة، ومن هو الأجدر من هاشم بتلك المهمة؟ عند اختياره لأداء هذه المهمة طار قلبه سرورًا، وما إن بدأ التحديق ببقعة الزيت الكبيرة الطافية على الماء المستقر في قعر الآنية حتى رآها تكبُر باخضرارها الفتيّ، ويرى نفسه تحلق في أفق بهيٍّ شفيف، بزرْقة سماوية تظلل غاباتٍ، وينابيع، وشلالاتٍ، تتدفق من الأعالي بلونها المترجرج، ثم تسيل، وتتفرع في سهول، ووديان، تتكدّسُ فيها الأشجار العالية والقصيرة، وفي لحظةٍ مباغتةٍ تظهر «المزيونة»، وهي تتراكض وسط ذلك المشهد في بقعةٍ طافيةٍ متشحةٍ بلوْن زيت الزيتون. فصرخ ملتاعاً»مزيونة» وقد تزامنت صرخته تلك – على ذمة الراوي – مع زغرودة ملأتْ الفضاء ندَّتْ عن الأمّ لدى رؤيتها «المزيونة» عائدةً بصحبة شرطيّ.
وهذه القصة - مثلما يتضح- أبسط من القصص الأخرى، وقد سَبَق لكتاب كثيرين أنْ عالجوا إيمان الناس بالخرافات وبالشعوذة. وبالكرامات التي تتحقق على أيدي بعض الشيوخ ممّن يشبهون، أو يختلفون، قليلا عن سليمان المغربي. فما أحسّ به الشيخ سليمان المغربي هنا من إحباط لأن شعوذته قصرت عن تحقيق ما نجح الباحثون عن الفتاة في تحقيقه شيء، يتكرر فيما يشبه هذه القصة من قصص، كذلك شعور (هاشم)بالاختناق، يشبه شعور الناس في القرى بأن ما كانوا يتهمونه من كرامات تتحقق على أيدي هؤلاء الدجالين ما هو إلا ضرْبٌ من الخداع.
يقتصر نجاح هذه القصة، إذاً، على لغتها القريبة جداً من لغة الحياة اليومية، فالأشخاص فيها يتكلمون بما يحيل الحدث إلى مشهد مألوف، والسارد الذي يتكلم يتلفظ هو الآخر بكلمات تحيل إلى مشهد مألوف. وموجز القول، في هذه القصص «سيدة الأعشاب» هو ارتقاء الكاتب فيها إلى مرتبة تقف القصة فيها على مسافة واحدة من السرد، والشعر، وهذا حسبه.