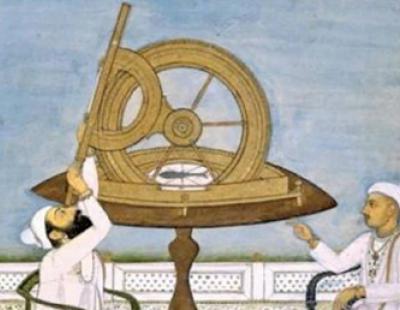العلوم العربية لا ينقذها تقليد الغرب بل التأصيل النقدي المعرفي
تكاد تقتصر وظيفة المجامع اللغويّة في البلاد العربيّة على تجسير الفجوة بين تقدم العلوم والفنون في الغرب وبين محاولة العرب اللحاق بذلك الركب العالمي، خصوصاً عبر ترجمة المفاهيم والمصطلحات الغربيّة كي تستوطن في لغتنا القومية. وعلى رغم ذلك، يكاد ذلك الجهد أن يقع في شبه غياب في المعاهد العلمية العربيّة (خصوصاً في العلوم الطبيعية). وربما رجع السبب في ذلك إلى تدريس التخصّصات الدقيقة العلوم بلغاتها الأوروبية مباشرة، بل غالباً باللغة الإنكليزية. وهناك استثناءات لتلك الصورة. وتصلح سوريّة مثلاً عنها، لأنها كانت تترجم المعارف الغربية برمتها إلى العربيّة كي تُلقى على طلاب الأزهر في «دار العلوم» التي أنشأها علي مبارك في الـ «كُتُبْخانة» الخديوية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
إذاً، تقلّص النشاط البحثي العربي في المستوى اللغوي على ترجمة المصطلحات والمفاهيم الغربية، وليس نحت مفاهيم عربيّة تعمل على إنتاج حلول تخصصيّة في مجالات المعرفة كلها. إذا نظرنا إلى الجامعات العربيّة، نجد أن التدريس فيها يستند إلى إعادة إنتاج حلول سبق اكتشافها في الغرب أساساً، من دون وضعها تحت النقد، بداية من اختلاف سياقاتنا عن السياقات التي أنتجت تلك الحلول، ما يعني الابتعاد عن بذرة البحث العلمي الباحث عن منهجيّة مستقلة. واستطراداً، لم نعجب لما وصل إليه حال التدني المنهجي للوضع البحثي في جامعاتنا العربيّة على المستوى الدولي؟ والأدهى من ذلك أن أعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا يثابون أضعافاً مضاعفة لو تمكنوا من النشر في دوريات علمية غربية شهيرة، حتى قبل أن تناقش مكتشفاتهم بلدانهم. كأن الاعتراف الغربي بما نبلغه من شأن في البحث العلمي هو أقصى ما نتطلع إليه!
الغرب يسعى إلى أصالة المهمّش
في تجربة شخصيّة، كان سهلاً على جامعة القاهرة نشر مجموعة من الكتب ترجمتها من ست لغات أوروبية. في المقابل، استعصى نشر ترجمة كتاب مكرَّس لبحوث أجراها علماء عرب معاصرين يعملون في فروع متنوّعة من المعرفة التخصصيّة. كان عنوان الكتاب المرفوض هو: «الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية: حوار عربي غربي» ورفضه «المشروع القومي المصري للترجمة» بدعوى أنّه «موجّه للغربيين وليس لنا نحن العرب»!
في المقابل، رحبت دار نشر غربية مرموقة بإصدار الكتاب عينه، بل كلّفت المترجم الإشراف على ترجمة سلسلة كتب إلى اللغة الإنكليزية، وهي تعنى بإعادة تشكيل الثقافة العالميّة استناداً إلى رؤية تهتم بإسهامات الثقافات المهمَّشة في العالم المعاصر. وبقول مختصر، تبدو الأكاديميا البحثيّة العربيّة تابعة تماماً للبحث العلمي في البلاد الغربية، بل إنّ البحث العلمي فيها مجرد قطوف منقولة عن الغرب، فتكون بعيدة من التأسيس المعرفي للفرضيات البحثية الأساسيّة. وفي أحسن الأحوال، لا تتجاوز أمور التأسيس المعرفي العربي عن كونها استنساخاً للنظريّات الغربيّة نفسها. وينطبق ذلك على العلوم الطبيعية وعلى الفنون بمختلف مشاربها. وعلى غرار الاقتصار على اجترار اجتهادات السلف في علوم الدين، يظهر اكتفاء بإعادة إنتاج معارف الغرب ثم يسمّى ذلك التكرار تحديثاً وحضارة!
إذاً، من الواضح أن هناك مأساة راهنة في العالم العربي تتلخص في إعادة إنتاج الآخر الغربي «المتقدم»، كما هو بلا إضافة أو إعادة نظر، بدلاً من أن العمل على إنتاج معارف أصيلة تنسجم مع الأرضية الثقافية للمجتمعات العربيّة. يحدث ذلك بجلاء في مجالات العلوم الطبيعية، كما يحصل في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيّة بأنواعها كلّها.
كما المسرح كذلك العلم
في السياق، من المستطاع استحضار تجربة تكثّف واقع الحال وهي مستقاة من الفن في تونس. ففي أواخر القرن العشرين، وسعياً للخروج من الإحساس بالتبعية للهيمنة الثقافية الغربية، لجأ بعض مخرجي المسرح إلى محاكاة تقنية الـ «كابوكي» في المسرح الياباني. ولم يكن ذلك مبنياً على اجتهاد في البحث عن حلول نابعة من خصوصية المجتمع التونسي في مرحلته التاريخية الحالية بإزاء طرق وأدوات عروضه المسرحية. وتلخّص الأمر إلى حدّ بعيد بمحاولة التخلص من الإحساس بالتبعية للمستعمر السابق الذي ما زال أثره طاغياً في ثقافات المغرب العربي. وما يحدث في المسرح بمصطلحاته الأوروبية، لا يختلف عن مجريات البحوث في علوم الطبيعة والعلوم الاجتماعيّة. إذ تتمثّل غاية «العلم» فيها بمحاكاة ما توصّل إليه الغربيون ثم محاولة «اللحاق بها» باعتبار ذلك «التحاقاً بالعصر الحديث». وفي المقابل، هناك حقيقة لا يعيها كثيرون تتمثّل في أن ذلك المسلك في حدّ ذاته هو الذي يكرس التخلف والتبعية، مع ما تتضمنه من إهدار للقوى الذاتيّة في الابتكار والإبداع. ولعله لا يفيد بسوى إشباع الحاجات المحلية للانصياع إلى الحلول الخارجية بأنواعها.
وما يثر مزيداً من الأسى أن التفكير النقدي في مسألة اتّباع الغرب من دون تفكير نقدي، يثر حفيظة أنصار العولمة، أو بالأحرى أنصار عولمة المعايير الغربية. وتثور ثائرتهم فيرمون بأسئلة مستنكرة، بدل من جعلها مدخلاً لتفكير مختلف. وتبرز في صفوفهم، بداية من الدوائر الأكاديميّة العربيّة ووصولاً إلى الـ «سوشال ميديا»، أسئلة من نوع «ما البديل»؟ «هل نرفض أسباب الحضارة العصرية وأدواتها بينما نحن لا ننتج بعضاً منها»؟ «ماذا لدينا أصلاً من إضافات بينما الغرب هو المهيمن على البحث العلمي المتقدم في عالم اليوم»؟
ماذا لو جرى التفكير نقديّاً بتلك الأسئلة، بدلاً من تبني إجابات سهلة عليها تنطلق من الاستسلام لهيمنة الغرب واعتبار تجربته «نموذجاً مطلقاً» لا يجري التعامل معها إلا بالانحناء والتسليم وتخدير العقل ونكوصه عن تنكب الدروب الصعبة للنقد والتأسيس المعرفي الأصيل.